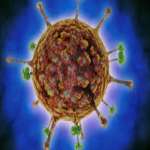عبادة تتجاوز الشعائر إلى المعرفة والهوية
بالرغم من البعد الجغرافي بين المغرب والأراضي المقدسة، يحتفظ المغاربة بعلاقة استثنائية بشعيرة الحج، تتجاوز بعدها الديني لتتشكل كمركب ثقافي واجتماعي وروحي متجذر في عمق الوجدان الجماعي.
ليس الحج عند المغاربة مجرد فريضة، بل رحلة ذات قيمة معنوية عالية، تترافق بطقوس واستعدادات تبدأ قبل عام على موعدها، وتتوج بمكانة خاصة للحاج داخل محيطه، واحتفاء اجتماعي.
يحظى الحاج المغربي بلقب تشريفي دائم يرافقه طيلة حياته، هو “الحاج”، الذي لا يُنادى به فقط، بل يُمنح مكانة رمزية تعبّر في الثقافة الشعبية عن الصلاح والبركة والوجاهة.
هذا الارتباط يتجسد أيضا في الأسماء العائلية التي لا تزال تحمل آثار هذه العلاقة التاريخية بالحج، مثل آيت الحاج وحاجي وحجاج، وهي ألقاب تحولت إلى علامات لهوية ثقافية متوارثة.
الشعيرة في الوجدان المغربي ليس مجرد عبور جسدي نحو مكة المكرمة، بل رحلة روحية وعلمية وأدبية
وترافق عودة الحجاج احتفالات شعبية تتراوح بين الاستقبال الحار بالمطار، وتزيين مداخل المنازل بالأعلام والألوان الوطنية، وصولا إلى التمر والحليب المقدمين رمزا للكرم والفرح، رغم تراجع بعض هذه الطقوس مع الزمن في المدن الكبرى.
الحج في الوجدان المغربي أيضا ليس مجرد عبور جسدي نحو مكة، بل رحلة روحية وعلمية وأدبية. فقد وثق المغاربة منذ قرون رحلاتهم إلى الحرمين الشريفين في كتب ومخطوطات ومؤلفات أدبية غنية، جعلت من أدب الرحلة نوعا خاصا ارتبط بالحج، كما في “الرحلة الكبرى” للشيخ الناصري، أو “رحلة الرحلات” للمؤرخ عبدالهادي التازي، التي عرض فيها لأكثر من مئة رحلة مغربية نحو مكة، أو في الروايات الأدبية الحديثة مثل “رواء مكة” لحسن أوريد و”تغريبة العبدي” لعبدالرحيم لحبيبي، ما يعكس استمرار حضور هذه الشعيرة في الأدب المغربي حتى اليوم.
كان الحج أيضا فرصة لتبادل العلوم والمعارف بين علماء المغرب والمشرق، إذ ساهمت الرحلات الدينية في إدخال المذهب المالكي إلى شمال أفريقيا، كما أشار ابن خلدون، ومكّنت علماء مثل أبي شعيب الدكالي من التألق في الحرم المكي، حيث شغل منصب إمام وخطيب طيلة 11 عاما.
وقد شكل موسم الحج في أوقات سابقة مناسبة نادرة للعلماء وطلاب المعرفة للقاء نظرائهم من باقي أنحاء العالم الإسلامي، مما جعل من هذه الرحلات مدارس متنقلة للعلم.
تاريخيا، لم يكن الحج رحلة فردية، بل عرف المغاربة ما يسمى بـ”ركب الحجيج”، وهو تقليد قديم نشأ في العصر الموحدي، حيث كانت القوافل الجماعية تنطلق تحت رعاية سلطانية أو دينية، وتعبر عدة بلدان قبل الوصول إلى الحجاز.
ورغم انحسار استخدام هذا المصطلح في العصر الحديث، ما زال يرد في الأدبيات الرسمية والثقافية، مثلما تفعل وزارة الأوقاف المغربية التي تحتفظ بتسمية “ركب الحاج” في بوابتها الإلكترونية الخاصة بالحج، وتحضر هذه التسمية أيضا في كتابات المؤرخ محمد المنوني.
برائة مثالية
ورغم هذا الارتباط الوجداني القوي، فإن الحج في المغرب يواجه تحديات اقتصادية واضحة، إذ تصل تكلفته عبر القنوات الرسمية إلى أكثر من 63 ألف درهم، ما يجعله حلما مؤجلا للعديد.
ومع ذلك، يواصل الكثير من المواطنين ادخار الأموال على مدار سنوات، أو الاستفادة من هبات الأبناء، أو الدعم الذي توفره بعض القطاعات الاجتماعية، في سبيل أداء الفريضة.
وفي كل موسم، يشارك أكثر من 350 ألف مغربي في قرعة الحج، ولا يُختار منهم سوى عشرة في المئة، وفق الحصة المخصصة للمغرب من إجمالي الحجاج.
وقد بلغ عدد الحجاج المغاربة في موسم 2024 حوالي 34 ألفا، تم تأطير غالبيتهم من قبل وزارة الأوقاف، بينما تولت الوكالات السياحية تنظيم رحلات الباقين.
ولا يقاس تعلق المغاربة بالحج ببعد المسافة، بل بعمق المعنى، إذ يجسد بالنسبة إليهم تجربة تجمع بين العبادة، والهوية، والتاريخ، والكرامة الاجتماعية. إنها رحلة تعانق فيها الروح ذروتها، ويتجلى فيها الإيمان في بعده الثقافي والإنساني، تماما كما ترويه الروايات، وتحكيه الكتب، وتخلده ألقاب العائلات وصور الاستقبال على أبواب البيوت.
ويعود تنظيم الحج في المغرب إلى مؤسسات ذات طابع رسمي صارم، حيث تتولى وزارة الأوقاف الإشراف المباشر على الترتيبات المتعلقة بالحجاج، سواء من حيث التأطير الديني أو التنظيم الإداري واللوجستي.
وتُشرف الوزارة على برامج تكوينية دينية مسبقة للحجاج، بهدف توحيد الممارسات وتجنب الأخطاء الفقهية أثناء أداء المناسك، وتحرص على اختيار مؤطرين من فقهاء وأطباء ومرافقين إداريين لمرافقة الحجاج في الديار المقدسة.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المغربية لضمان أداء آمن وسليم لهذه الفريضة، في ظل ارتفاع أعمار العديد من الحجاج وخصوصية المناخ والتنقل في موسم الحج.
الحج كان فرصة لتبادل المعارف بين علماء المغرب والمشرق، ما ساهم في إدخال المذهب المالكي إلى شمال أفريقيا
ومن جانب آخر، تُشكل العلاقة التاريخية والدبلوماسية بين المغرب والمملكة العربية السعودية أحد العوامل التي تعزز انسيابية عملية الحج، سواء من حيث التعاون القنصلي أو التفاهم على مستوى بعثات الحج الرسمية. وغالبا ما تُعقد لقاءات ثنائية بين مسؤولي الشؤون الدينية في البلدين للتنسيق بشأن ترتيبات كل موسم.
وقد شهدت عملية تنظيم الحج تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مع إدماج خدمات رقمية مثل التتبع الإلكتروني، وحملات التوعية عبر التطبيقات والمنصات الرسمية، إضافة إلى اعتماد آليات مراقبة صارمة على الوكالات السياحية لتفادي أي تجاوزات أو استغلال مالي، وهو ما يعكس حرص الدولة على أخلقة خدمات الحج وضمان كرامة الحجاج.
وعلى المستوى الفقهي، لا يزال المذهب المالكي، الذي يمثل المرجعية الدينية في المغرب، يطبع الفتاوى والتعليمات المتعلقة بالحج، بما يضمن نوعا من الانسجام المذهبي داخل بعثة الحج المغربية. هذا التوجه يُترجم في برامج التكوين والإرشاد، حيث يتم التركيز على خصوصية المدرسة المالكية، وتبسيط الفقه للحجاج بطريقة عملية وميسرة.
وأما في المجال الأكاديمي، فقد أصبح الحج أيضا موضوعا متزايد الاهتمام في الجامعات المغربية ومراكز البحث الديني والأنثروبولوجي، حيث تُنجز أطروحات ودراسات حول تمثلات الحج في الثقافة المغربية، وعلاقته بالتحولات الاجتماعية والدينية، كما يتم تحليل بعده الرمزي في الأدب الشعبي والسرديات المحلية.
ولا يمكن إغفال أن الحج في المغرب يرتبط كذلك بمكانة أوسع في الخطاب السياسي والديني، حيث يُنظر إليه كأحد المؤشرات على مستوى الحرية الدينية، وعلى مدى قدرة الدولة على إدارة الشعائر الكبرى في الإسلام، ضمن توازن دقيق بين متطلبات التدبير العمومي واحترام الخصوصية الدينية للمواطنين.